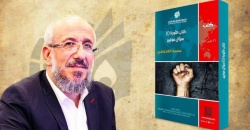كتاب الثورة 15 الحسم الثوري: تحولات المعارضة
محمد القدوسي
كان انطلاق حراك 25 من يناير ضربة موفقة، نجحت في إجبار دولة الجنرال على “استبدال” رأسها، وليس على “التخلي” عنه، إذ ذهب “مبارك” ليأتي “المجلس العسكري”، وهي مجرد خطوة كان يجب استمرار العمل بعدها في اتجاه “الثورة”، التي لا يعد من أعمالها ما حدث من “تجديد ولاية العسكر” ليستمروا في المنح والمنع، وإطلاق التهديدات، وتحديد المسموح به والممنوع، ثم الامتثال لهم في النهاية، أو ـ على أحسن الفروض ـ التفاوض لتحسين شروط الإذعان! ثم وضع جماهير غير مؤهلة، لا من حيث الوعي ولا من حيث التنظيم، في مواجهة صفرية مع العسكر من دون أي حساب للأدوات ولا لزمن الصراع المحتمل ولا للظروف المحيطة به محليا وإقليميا ودوليا، ليصبح على الجماهير (المفتتة والمسدود أمامها أفق الثورة) أن تفاضل بين الانتحار، عبر الاستمرار في تقديم التضحيات المجانية التي لا تفضي إلى شيء ولا تضيف الكثير إلى رصيد الثورة، وبين الاستسلام، بأشكاله المختلفة.كانت “دولة الجنرال” ـ بذهنيتها وشخصيتها ـ ومازالت هي الأكثر حضورا ـ حتى في ساحة الثورة ـ عبر “قوى سياسية” نشأت في ظلها، سواء تحت رعايتها أو في ظل المنافسة المسموح بها مع بعض مكوناتها، تعاملت مع الحراك الثوري باعتباره مجرد فرصة للاستئثار بالسلطة أو زيادة الحصة منها، من دون أي تطلع للتغيير الذي خرج هذا الحراك أصلا في سياقه وللمناداة به، بل إنها عمليا كانت تسد أفق هذا التغيير، عبر المناداة بالاستقرار، والركون إلى “الجنرال” أو التطلع لاكتساب ثقته، والحفاظ على سلطات وأدوات حكم العسكر كما هي، والحيلولة دون إعادة توزيع الثروة.
إنها الانتهازية التي رأيناها تطل على ساحات الثورة عبر الزمان والمكان، باعتبارها نتاجا تاريخيا ومرحلة تعقب الحراك، تعبر عن تفاعل مجتمعي حقيقي لا يمكن إيقافه إلا بتعديل مكوناته و”من السذاجة تمني إيقافه بواسطة مادة موجودة في الدستور” كما تقول روزا لوكسمبورغ مؤكدة أن وجود الانتهازية يتعلق بجوهر الصراع.
لكن الأمر ـ في الحالة المصرية ـ لم يكن أمر “الوجود” فحسب، بل “الصعود” إذ لم يكتف الانتهازيون بمزاحمة الثورة على ساحتها، والاندساس بين حشودها، بل هيمنوا على الحراك الثوري، وأصبحوا في صدارته بفضل امتلاكهم دولاب عمل مستقر بآلياته وخبراته، لم يكن عليه للخلاص من حراك الجماهير العفوي إلا أن يلعب دور القاطرة، التي تقود عربات الحراك، ولاحظ أن العربات هنا لا تفقد المبادرة وتسلم إرادتها للقاطرة فحسب، بل إنها تصبح جزءا منها، مجرد عضو في جسد يتناغم معه ويعمل لصالحه، وهكذا كان الأمر بين ثورة بلا قيادة، وقيادة بلا ثورية، إذ تمرست طول حياتها على أداء دور المعارضة (التي هي جزء من النظام) بطموح أن تنجح في الحصول على جزء من السلطة، وهو طموح تظل لا تملك غيره، برغم أنه لا يتحقق إلا نادرا، وبصورة محدودة جدا.
ونتوقف هنا قليلا لتأكيد ما سبقت الإشارة إليه (في الفصل الأول تحت عنوان “عن الإصلاح والمعارضة”) بشأن طبيعة المعارضة وأنها جزء من النظام، بل إنها ذلك الجزء الذي يصبح في ذرى الصدام والاحتدام أقرب إلى السلطة حتى من الموالاة نفسها، وهو ما فعله معارضو “البلاشفة” عندما دعموا الحكومة الروسية المؤقتة (القشة الأخيرة التي تعلق بها نظام القيصر) وشاركوا فيها، كما شاركوها في 17 من مايو/أيار 1917 في الهجوم على حشود من المتظاهرين تجاوز عددها 100 ألف من الثوار مؤيدي البلاشفة، وهم هؤلاء الذين وصفت المعارضة “أريادنا تيركوفا”* في رفض واضح لمسلكهم منذ الخميس 8 من مارس 1917 بأنهم “الغوغاء في المقاطعات العمالية، الذين ينهبون المتاجر، ويجوبون الشوارع هاتفين: الخبز”*. مع أنها هي نفسها تيركوفا التي سبق أن كتبت مادحة أيام الحراك الثوري: “في تلك الأيام كان حسن الخلق وحسن النوايا هما السائدان، وقد خلقا إحساسًا مشتركًا قويًا ينضح بالقوة والحيوية”! وأترك لكم مهمة المقارنة ـ أو المطابقة ـ بين ما تسجله العبارتان من تناقض، وبين عبارات تحمل التناقض نفسه لمعارضين مصريين احتفوا ـ أشد الحفاوة ـ بأيام ميدان التحرير الثمانية عشر، قبل أن يصبوا جام غضبهم ومقذع هجائهم على الثوار بدعوى أنهم يزعزعون الاستقرار ويعرضون البلاد للخطر، مع أنهم لا يهددون إلا “حكم العسكر”.
وثمة صياغة قاطعة لهذه الفكرة تتطوع بها أريادنا تيركوفا، وهي صحفية روسية ليبرالية، وعضو في حزب الديمقراطيين الدستوريين (الكاديت) الليبرالي، وزوجة الثري الإنجليزي هارولد ويليامز، هربت من روسيا بعد إسقاط القيصر، في 1918، ونشرت كتابها “من الحرية إلى بريست ـ ليتوفسك” عن الثورة البلشفية، وفي العام التالي مباشرة عادت إلى روسيا لمساندة الجيش الأبيض (المعادي للثورة، يعني عسكر الثورة المضادة) في الحرب الأهلية، ولتقول ـ كثر خيرها ـ بعبارة لا لبس فيها “يجب أن ندعم الجيش أولاً وأن نضع البرنامج الديمقراطي في الخلفية. يجب علينا خلق الطبقة الحاكمة، وليس ديكتاتورية الأغلبية. إن الهيمنة العالمية للديمقراطية الغربية مجرد غش، فرضه السياسيون علينا. يجب أن تكون لدينا الشجاعة للنظر مباشرة في عيون الوحش، الذي يسمى الشعب”. هكذا بكل وضوح: الشعب وحش، والسيدة (المعارِضة) تريد أن تملك (شجاعة) القدرة على التحديق في عينيه مباشرة، وتعرف أنها لن تملكها إلا بدعم العسكر، في ظل طغمة حاكمة، أما الديمقراطية فمجرد خدعة، وأما الأغلبية فيجب استبعادها.
حسنا: هل استوعبتم ما سبق؟ إن هذا هو ـ بالضبط ـ ما تطرحه المعارَضة حين لا يبقى من النظام، المتآكل في سياق الثورة، إلاها، وتكون “المخزن” الأخير لجيناته والأمل الباقي الذي يلتف حوله أنصاره الراغبون في استنساخه. هؤلاء الأنصار الذين يخطئ جدا من ينظر إليهم باعتبارهم قلة لا وزن لها، فهم فضلا عن امتلاكهم مفاتيح السلطة وخبراتها، يمتلكون أيضا حصة انتخابية مؤثرة، لا تختفي بمجرد اندلاع الثورة، لدرجة أن “بينوشيه” وهو يسقط نجح في دفع 43% من شعب تشيلي للتصويت لصالحه، وأحمد شفيق حصد ـ في أوج الحراك الثوري ـ 48% من الأصوات. وفي المقابل فشل البلاشفة في الحصول على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية التي تشكلت في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 1917، أي بعد أيام من نجاح ثورتهم (25 من أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 من نوفمبر/تشرين الثاني 1917) حيث حصل الاشتراكيون الثوريون على الأغلبية، وظل الكاديت في الصورة (وهما اللذان كان لينين يسميهما: الفوضويين، والديمقراطيين البرجوازيين الصغار) ليضطر لينين إلى حل الجمعية في يناير/كانون الثاني 1918 ما أعطى إشارة بدء الحرب الأهلية.
وهكذا فإنه من الضروري جدا إدراك أن المعارضة (وبرغم الدور المهم والملهم الذي تلعبه في المراحل المبكرة من التمهيد للثورة) تظل جزءا من النظام، فلا هي من الثورة، ولا هي ـ كما يحسب البعض ـ نقطة متوسطة بين الثورة وبين الموالاة، ولا المنخرطون فيها يقيمون ـ منذ انطلاق الحراك الثوري ـ وزنا لأية صلات سياسية (وربما أيضا اقتصادية واجتماعية) نشأت بينهم وبين مشاركين في الثورة، ولا وزنا لموجة “التوحد” التي صاحبت انطلاق الحراك الثوري، وبدا وكأنها أعادت صياغة المجتمع كله ليصبح كتلة واحدة، وعلى أية حال فإن هذا ما يحدث عادة في الثورات، حتى إذا ما أوشك النظام على السقوط، وتحددت حسابات المكاسب والخسائر، فإن الكتلة تعود مرة أخرى للتمايز إلى وحداتها الصغيرة، وحدات “الكيانات السياسية” من أحزاب وجماعات، التي لا عمل لها إلا “الصراع على السلطة” والتي لا تعرف عن “الحشد الشعبي” أكثر من أنه أداة من أدوات هذا الصراع، الذي يدور في أفق وعلى أرضية “الدولة” التي ينتمون إليها، والتي هي ـ وليس الأمر مصادفة ـ نقيض الثورة التي قامت لإزاحة أنقاضها. وهكذا فإن هذه الكيانات لا تتعامل مع “الثورة” إلا في حدود كونها وسيلة للاستحواذ على السلطة (وليس لتغيير المجتمع تغييرا جذريا) ونتيجة لهذا فإن شركاء الأمس من المعارضين هؤلاء، وحالما يتصورون أنهم وصلوا إلى تقاسم مرضٍ للسلطة، لا يخفون رغبتهم في “الاكتفاء بهذا القدر من الثورة” ما يعني توقفها، لا لأن الثورة “جائحة لا يمكن أبدا التحكم في قدرها” فحسب، ولكن لأن الثورة ـ في بنيتها ـ ليست مجرد أداة للوصول إلى السلطة، ولأن وصول أي من قوى “الدولة المتحللة”* إلى السلطة يعني عرقلة المسار الثوري.
ومرة أخرى أذكر بأن الثورة ـ أية ثورة ـ من شأنها أنها مستمرة “حتى يظهره الله أو أهلك دونه”. وأن الانتقال من الانخراط في الثورة الشعبية، ولو بالتحول من “الانخراط” إلى “تأييد” مؤطر بحدود وشروط، يعني ـ بالضرورة ـ الانخراط في الثورة المضادة، التي لا تتطلب المشاركة فيها فعلا، بل يكفي إبداء الخضوع، ولا يهم إن جاء هذا الخضوع تعبيرا عن الرضا أو مظهرا للاستسلام، مادام في كل الأحوال يسقط أصحابه في رحى القهر، التي تطحنهم حتى لا يكونوا شيئا مذكورا، عندما تصبح “الثورة المضادة” هي “الثورة المستمرة”.
كما أن إعلان التحول عن موقف “الثورة” إلى موقف “المعارضة” هو إعلان بالتحول إلى جزء من النظام والانضمام ـ بالتالي وعلى نحو أوضح ـ إلى معسكر الثورة المضادة. ولا يصح هنا الاحتجاج بأن هذا من قبيل “المناورة” لأن المناورة تعني “التظاهر” ونحن بصدد خطوة حقيقية تتلوها خطوات على دربها. ولأن المناورة تستلزم وجود “خطة بديلة” وهي خطة لا تظهر أبدا في سياقات المرتدين عن الثورة، ولأنها كذلك تعني التحرك المحدود داخل الإطار نفسه (مثل المراوغة في كرة القدم التي يجب فيها ألا تخرج الكرة عن حدود الملعب) ولا يعد من قبيل المناورة الخروج نهائيا عن السياق، ناهيك عن الانتقال إلى سياق مناقض. كما أن المناورة لا تكون على حساب انسجام الكتلة التي تقوم بها، وإلا تسببت في تحطيمها على نحو حقيقي لا يجدي معه الاعتذار بأنها كانت مجرد مناورة، وحين تمضي القيادات بكتلها السياسية من جانب الثورة إلى جانب المعارضة، غير عابئة بجماهيرها التي تركتها عالقة في استحقاقات الثورة، مثل المعتقلين والمطاردين والمشتبكين في مواجهات وذوي الشهداء، وهم جميعا أعداء للثورة المضادة التي تصبح القيادات جزءا منها، مخالفة “العلاقة التعاقدية” التي يواصل هؤلاء دفع حصتهم فيها، فإن القيادات هنا لا تخسر ـ فحسب ـ هذا الوزن الحيوي والمؤثر من كتلتها، لكنها تخسر الصيغة الحاكمة لبنية هذه الكتلة، التي تصبح طاردة لمن كانوا من قبل يشكلون قاعدتها الأساسية، وهي حقيقة لا يمكن إخفاؤها لوقت طويل وراء غلالات الدعاية ـ مهما كانت سوداء ـ ولا التذرع بحجة كل مستبد من أنه “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” إذ تنكشف الحقيقة، التي هي “أطول عمرا” كما يقول “شوبنهور” وهي “تحرركم” كما جاء في الإنجيل منسوبا إلى المسيح عليه السلام. ومثلما تنكشف حقيقة الإرهاب الذي يتذرع العسكر خفر الإمبراطورية بالحرب عليه مبررين مذابحهم وقمعهم ومختلف جرائمهم، ينكشف استخدام “الشرعية” ذريعة يتستر وراءها المرتدون عن الثورة، لتبرير بقائهم في مقاعد القيادة، برغم هذه الردة، التي يدلسون بأن رفضها هو رفض للشرعية، في قلب بيِّن للحقائق.
ذلك أن الثورة لا تعتد إلا بالشرعية الثورية، التي هي قيمة معنوية تقر في النفوس نتيجة وحدة المنطلقات والأهداف، وتثق الجماهير في القيادات التي تقتنع بأنها تمثل هذه الشرعية، طالما ظلت قادرة على إقناعها بأنها ملتزمة بها. ولا يكفي التذرع بالمشروعية ـ التي هي مجرد إجراءات ـ لتصدير هذا الاقتناع. ذلك أن المشروعية لا تنشئ الشرعية، لكنها إجراءات تكشف عن اعتقاد الجماهير بوجودها، ومن تآمروا على الثورة، وخانوها لصالح العسكر ـ بوعي ورضا كامل ـ كان بينهم من حاز مشروعية الانتخاب، حيث عقدت له الجماهير لواء تمثيلها في مرحلة ما، وبديهي أنها مشروعية انتهت بنهاية الشرعية التي وجدت في سياقها.
هكذا انتهت مشروعيات كثيرة، جاءت في سياق شرعية الثورة، ثم تساقطت، ولم يبق ما يمثلها فعلا إلا شرعية الرئيس “د. محمد مرسى”، التي لا تنبني على “مشروعية” انتخابه شعبيا بمشاركة ما وبنسبة ما، بل على “السياق الثوري” الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، ثم ـ وهو الأكثر أهمية ـ على التزام الرئيس بهذا السياق عبر صمود كان له فضل كبير في استمرار الفعل الثوري والتضييق على “الثورة المضادة”. وهو صمود لا يمكن اختزاله في حدود “الصراع السياسي” بين العسكر والإخوان، أو بين “الإخوان” بصفتهم فصيلا معارضا وغيرهم من الفصائل، ولا يمكن تجييره لصالح هذا الصراع أو ذاك، ولا اختزاله ليصبح مجرد أداة في صراع. كما لا يمكن اختزاله في أنه “اختيار شخصي” إذ هو ـ بالطبيعة وبالنتيجة ـ عمل ثوري، بتجاوزه المصلحة الخاصة، بل بالتضحية بها في سبيل “المصلحة العامة” كما يقرها “السياق الثوري”. وبثمرته التي لا شك فيها من فضح تلفيق وهشاشة مشروعية “الثورة المضادة” وتسهيل مهمة “شركاء الثورة” على الاستمرار على دربها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هؤلاء الشركاء خارج سياق الثورة. ومن هنا يمكن الحديث عن أهمية “استرداد الرئيس” لصالح “السياق الثوري” وليس “الحزبي” ولا “الشخصي”، وعلى أساس أسمى من “إجراءات الانتخابات” ومن دورة الرئاسة، وكم مر منها، وعلى أي أساس تحتسب. لكن هذه الشرعية ـ وبكل أسف ـ تستخدم لإضفاء شرعية زائفة على سياق تجاوزه الزمن، وأصبح محكوما بالانزواء مع بقية أشلاء الدولة المتحللة التي هو جزء منها، كان ـ ومازال ـ يعمل في إطار مفاهيمها ووفق معاييرها.
لقد ضحى “المواطن” محمد مرسي بحريته واستقرار أسرته، وجازف بحياته وحياتها ليحافظ للثورة على الرئيس الذي انتخبته جماهيرها، وليقدم دليلا إضافيا على طبيعة حراك 30 يونيو، باعتباره ردة تأتي ضمن سياق الثورة المضادة، لم تنجح في تأسيس شرعية، ولا أنتج سياق إجراءاتها القمعية إلا مشروعية حكم العسكر، التي لا يسندها غير انتخابات لا يعيبها فقط أنها صورية ومزورة، بل يسقطها من الأصل أنها ما كان لها، ولا كان من المتصور، إلا أن تجري على النحو الذي جرت به: صورية ومزورة. وحسبك أن الشخص الذي أعلنته رئيسا، وهو “عبد الفتاح السيسي” كان يترأس سلطة العسكر الحاكمة من قبل إجراء الانتخابات، ما يعني أنها لم تضف إليه شيئا، وأن الجميع يعلم أنه باق يترأس سلطة العسكر، حتى ولو لم تجر الانتخابات في موعدها الدوري، ما يعني اقتناعهم بأن الانتخابات لن تنقص منه شيئا، وهو تصور صحيح، فالانتخابات أداة لتداول السلطة (الذي لا تسمح به سلطة العسكر) وليست وسيلة لإسقاط النظام (كما يريد الثوار)؛ ولهذا يفشل من يحاولون استخدامها في هذا السياق.
ويكفي لتأكيد هذا المعنى، النظر إلى مصائر من سعوا إلى منافسة “السيسي” على رئاسة حكم العسكر، أو كانوا في وضع ربما يسمح لهم بهذا، حتى وإن كانوا من العسكريين: أحمد شفيق الذي نكل به وأجبر على إعلان التراجع عن إعلان “نية” الترشح. وأحمد قنصوه الذي حكم عليه بالسجن. وسامي عنان، قائد السيسي السابق، المحكوم بالسجن. وأعضاء المجلس العسكري، الذين تم إبعادهم جميعا. أما المدنيون فبقوا على قيد الحياة السياسية بقدر حاجة السيسي لاستخدامهم، وإلا فإن عليهم إعلان نهايتهم بأنفسهم، مثل عمرو موسى الذي صنع من مذكراته تابوتا فخما وكان إصدارها بمثابة جنازة وسرادق عزاء كبير. وحمدين صباحي الذي كانت الحاجة لوجوده في “صورة الانتخابات” الأولى ماسة، وبرغم هذا جاء ترتيبه ثالثا بعد السيسي والأصوات الباطلة، في إهانة متعمدة ونتيجة مزورة، واستمر الإعلام في التشهير به، وبأسرته، حتى أجبر على إعلان أنه خارج السياق، وليس خارج السباق فقط. وأخيرا “خالد علي” الذي وجد نفسه هو الآخر مجبرا على المعاناة مع مهمة “المنافس الوحيد الذي يلائم احتياجات السيسي”، هو المحاصر بحكم من قضاء سلطة العسكر يحمل طابع “الماس بالشرف” يدينه بتوجيه إشارات بذيئة وفاضحة، وهو حكم يجعله قيد التحكم ومأمونا.
وبرغم سخف وبؤس ورثاثة مشهد ما يسمى “الانتخابات الرئاسية” برمته، فإن ملمحا واحدا فيه يظل جديرا بالانتباه، وهو أن الرغبة البالغة في الانتقام من كل من يشير أدنى إشارة إلى احتمال الخروج على تقديس الجنرال، هي الأمر الوحيد الذي يبدو جادا وحقيقيا وسط ركام من الهزل والتلفيق، وهو سلوك يشير إلى أحد الفوارق الأساسية بين الثورة، وبين الثورة المضادة، فالأولى تطرح منهجها وتخوض حربها ضد (ما) يعوق التغيير الذي تسعى إليه، بينما الأخرى تفرض سلطتها وتخوض حربها ضد (من) يخالفها. وهي صفة تشكل نقطة تماس بين “الثورة المضادة” و”المعارضة”، إذ يمثل “الأشخاص” موضوع كل منهما، وهو تماس يتيح العبور ـ الآمن غالبا ـ بين المعسكرين، ويحولهما ـ في نهاية المطاف، وبغض النظر عن اختلافات التفاصيل ـ إلى جبهة واحدة في مواجهة الثورة.
والأكثر من هذا أن خصائص “المعارضة” تجعلها رافدا مهما يدعم حكم الطغمة، ومنه حكم العسكر، وكما أشرنا من قبل فإن السلطة تجد في “المعارضة” وليس في “الموالاة” ملاذ ما قبل الانهيار، وهو ملاذ كثيرا ما نجح في أن يمنحها ـ بثمن بخس ـ وقتا إضافيا ثمينا.
لكن قبل هذا فإن المعارضة، في سياق الاستبداد، هي “الثقل المقابل” الضروري لتوازن السلطة، التي يصبح بوسعها أن تدعي الديمقراطية وهي تستدعي المعارضة، الهزيلة المقيدة، للعب دور المنافس في الانتخابات. وأن تدعي البطولة وهي تنتصر عليها، بل تسحقها. وأن تدعي الالتزام بالقانون، الذي هو قانون السلطة المكتوب بيديها ولمصلحتها، بينما هي في الحقيقة تنكل بالعدالة. كما يمكن للسلطة ـ في كل الأحوال ـ أن تدعي البطولة مادامت تحقق ـ كلما شاءت ـ انتصاراتها الرخيصة على “معارضتها” التي تضمن بقاءها رثة طالما ظلت في الإطار المرسوم لها، بحيث لا تتجاوز النزاع على إدارة المؤسسات إلى الصراع على بنية الدولة.
لهذا ما كان لهذه المعارضة، ولا كان من المتصور لها، أن تكون طرفا أصيلا في الحراك الثوري، ولهذا أيضا فإن أفضل ما قدرت على أن تطرحه هو “الاصطفاف” بمعنى الوقوف صفا واحدا، وهو أكثر أشكال الوحدة بدائية وخواء من المضمون، إذ إن وحدة الصف لا تدل بالضرورة على وحدة الهدف ولا المنطلق ولا المنهج، كوحدة الواقفين ـ في صف واحد ـ لشراء تذاكر السفر، بينما تختلف مواعيدهم ووجهاتهم وأهداف رحلاتهم ومددها.. إلخ. ومع وجود هذه الاختلافات، ولتفادي أثرها، فإن الاصطفاف هنا يقوم على تنازل كل فصيل معارض عن جزء من أفكاره، لنصبح بصدد مكونات يجمعها “النقص” من ناحية و”التربص” من ناحية أخرى، ولو كان “فؤاد حداد” بيننا لقال:
- طبيعةْ صامتةْ
- شجنْ أحلامْ
- ممنوعْ تَبَادُلْ الاستسلامْ
ولظلت المعارضة برغم ذلك تتبادل استسلامها، في “اصطفاف” تبدي به ما هو أكثر من رغبتها في مواصلة خدمة السلطة، إذ هي لا “تبدي” بل “تسدي” إليها الخدمة فعلا، بمغادرتها “التضامن” الثوري (الذي يعني تمسك الجميع بمجموعة الأهداف الأساسية، مع طيف من الأهداف الثانوية هي محل “تفهم” حتى بالنسبة لمن لا يتمسك بها، ما يضمن وجود وحركة الثورة في كتلة متجانسة) إلى اصطفاف يرسخ الخلافات ويعمق النزاعات ويضمن تنازل الجميع عن جزء من وجودهم، لا لصالح بعضهم بعضا، بل لصالح سلطة العسكر، إذ تظل الطرف الوحيد الذي لا يقدم تنازلات، كما تظل هي “الوسيط الحسابي” و”مركز الثقل والاتزان” بين الفصائل المتنازلة، حيث يهرع الجميع إليها، عند الخلاف على مقادير التنازل. والحاصل فعلا أن اقتتالا داخليا شديدا يقع في داخل كل كيان سياسي يدعو للاصطفاف مع الآخرين، وهو اقتتال يخفت إلى درجة التلاشي، إذا ما كانت الدعوة للاصطفاف مع العسكر، وأن سلطة العسكر لا تعتمد في بقائها على ما تقدمه، وفي الواقع فإنها لا تقدم شيئا بل تسلب وتؤخر وتنتهك وتفترس، لكن هذه السلطة تعتمد على استثمار المخاوف وترويج وهم أنها النقطة المتوسطة بين الاتجاهات المتعارضة، بينما الحقيقة أنها نقطة القضاء على الاتجاهات كلها، وبالعودة لمثال محطة السفر فإن حكم العسكر لا يعني وصول القطار إلى منتصف المسافة بين الاتجاهات المتعارضة، بل نسف القطار وخلع قضبانه وتقييد حرية السفر، ثم إتاحة الفرصة أمام المعارضة لإعادة الاصطفاف مرة ومرات تحت لافتة المطالبة بما نسف وخلع وقيد، ثم اعتبار هذه المطالبة نضالا، واعتبار الفتات الموسمي الذي يمكن أن تحصل عليه مكاسب!
وهو سلوك ـ في حالة المعارضة المصرية ـ لا يعزى كله إلى بنية دولة الجنرال، التي انعكست على مكوناتها، والقائمة على الاستهانة بالجماهير (استبعاد الأغلبية) والتشرذم (حيث الأقليات متساندة مجرد تساند فلا هي تندمج ولا هي حتى تترابط) ومركزية السلطة (الجنرال في القلب) التي تفضي بالضرورة إلى سيادة الانتهازية ومفرداتها من المحسوبية والتزلف وعدم المبالاة بالوازع الأخلاقي والصالح العام، كنتاج طبيعي. لكن الجانب الأكثر أهمية من أسباب هذا السلوك للمعارضة المصرية، يأتي نتاجا لتاريخ طويل من تساقط عدة حراكات ثورية غير مكتملة، على نحو جعل مصر أشبه بـ”حوض ترسيب تاريخي” لبقايا الثورات المضادة التي أجهضت هذه الحراكات، ولهذا تعثرت الثورة وسط كيانات كلها معاد، وكلها يحاول أن يختطف من لحمها القطعة التي يحسب أنها تخصه، في مناخ لم يكن مواتيا للثورة المضادة فحسب، بل هو مناخ كله من الثورة المضادة، متمثلا في مخلفات وبقايا مواجهات مع حراكات ثورية بائسة جاءت كلها بمنطق “التحدي والاستجابة” تأكيدا لغياب الوعي الجمعي، وأن الجماهير لا تتحرك إلا عند تعرضها لاستفزاز مباشر، يأتي حراكها في حدود الرد عليه، ويظل من دون إنجاز تقريبا، والقليل الذي يمكن أن يتحقق يظل مرتهنا بالمدى القصير والأثر المحدود وعدم القدرة على الصمود أمام المتغيرات التالية، ولهذا تآكلت الحراكات ولم يبق إلا مخلفات الثورات المضادة التي قامت لإسقاطها.
وهنا يمكن رصد حراك “التحرر” الذي جاء استجابة لتحدي “الاحتلال” المباشر الفرنسي ثم البريطاني، وبرغم الفرق الكبير في تفاصيل التعامل مع كل منهما فإن سلوك الثورة المضادة هو ما بقي منهما معا، ممثلا في مركب النقص، واختزال الوطن في الحاكم ودولاب البيروقراطية، والدعوة إلى “الاستسلام” باعتباره هو “الاستقرار”، ولم يبق من حراك “التحرر” إلا ذكريات تتعلق بقصص الأبطال، اختلط فيها الخيال بالحقيقة، وأصبح “الوعي” محض تهويمات. وحين اكتشف المصريون في “التخلف” عدوا حقيقيا، هو الذي مهد للاحتلال، وخاضوا ضده حراك “التحديث”، رفع الجنرال في وجوههم راية “التقاليد” وسلط الأكثر رجعية من أقلياته على دعاة التحديث يتهمهم بالمروق والانحلال والفسوق والتغريب.. إلخ. وهكذا انكسر حراك التحديث ولم يواصل الطريق الشاق، الذي لم يكن هناك ما يمكن أن يعين عليه إلا تكاتف الجماهير، وتبنيها للدعوة، وتصويبها لمسار لم يبق منه فعليا إلا القليل من التحديث والكثير من التبعية والانبهار، وهكذا سقط حراك التحديث ولم تبق إلا ثورة التخلف المضادة. وعندما انتبه المصريون إلى تمييع “الهوية” باعتباره المدخل الذي مكن الاحتلال البريطاني من البقاء مستقرا 72 سنة، لم يجلُ بعدها إلا لأن الإمبراطورية البريطانية ضعفت وتحللت، وخاضوا حراك إحياء الهوية والتمسك بها، جاءت الثورة المضادة لتتهمهم بالرجعية، رافعة شعارات التغريب والانفتاح، لتهرس ما تبقى من قيم فردية وتسحق المواطن. وهو ما انتبه إليه حراك يناير الثوري، الذي خرج مطالبا بالحريات الفردية السياسية والاجتماعية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) ليجد نفسه محاصرا بثورة مضادة هي نثار ما فات كله، فإذا كان الثوار من الملتزمين بالهوية فهم “رجعيون” وإن لم يكونوا فهم “منحلون” وربما “عملاء للغرب”. كما أنهم بدعوتهم للحرية والكرامة يهدمون الاستقرار، ودعوتهم للتحديث تهز الثوابت، إلى غير هذا من افتراءات يوجد دائما البوق المناسب لترديدها في مخلفات الثورات المضادة، التي يوشك المرء ألا يجد غيرها أينما ولى وجهه، والتي اجتمعت كلها منذ نجح “حلف الثورة المضادة” في فرض “التيارات والقوى السياسية” بديلا عن “الحشد” بعد أسابيع من انطلاق حراك يناير الثوري، وصولا إلى تشكيل “مرقعة” مشهد انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013، الذي تجاور فيه أدعياء التقدمية مع “العاطلين بالوراثة” من بقايا الأرستقراطية، كما تجاور المطالبون بطرد المسلمين إلى الجزيرة العربية مع المنادين بتهجير المسيحيين إلى كندا. كلهم وقفوا معا برغم أنه لا رابط يجمعهم إلا “حوض الترسيب” الذي جاءوا من مخلفاته التاريخية، وعصا الجنرال التي تسوقهم جميعا طوال الوقت. وهو ما يذكرنا بما قاله “ماركس” في “المانفيستو” من أنه ” كانت الحركات كلها إما حركات أقليات، وإما لمصلحة الأقليات” مع ملاحظة أن الأقليات هنا تنسحب على أصحاب الرؤية المحدودة وليس بالضرورة أن يكون عددهم أو تمثيلهم محدودا. بينما الثورة وهي “الحركة القائمة بذاتها، للأغلبية الساحقة، في سبيل الأغلبية الساحقة، لا يمكنها أن تنهض، من دون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلف المجتمع الرسمي”.
على أن حراك يناير يظل متميزا بأنه الأول الذي مس الوتر الصحيح، مطالبا بإسقاط دولة التكلس والبقايا والتخلف والتبعية، مع هتافه بسقوط حكم العسكر. يناير هو الالتفاتة العفوية الأولى إلى الفرق بين “الدولة” و”الوطن”، والإشارة الأولى إلى أن “المواطن” لا السلطات ولا المؤسسات هو جوهر الوطن ومعناه الحقيقي.
يناير هو فاتحة الوعي، والإدراك الأول لطبيعة “بيئة الثورة المضادة” التي لا يمكن أن يعيش فيها إلا “حكم العسكر”. مع إدراك معضلة التشظى التي حكمت حراكات ثورية لم يعوزها النبل ولا التضحية، بل الوعي، لتتعثر لأنها لا ترى. صحيح أن حراك يناير تعثر هو الآخر، وعانى ـ كسابقيه ـ نقص الوعي، لكنه وإن لم يتح الرؤية الصحيحة، في اكتمال تجليها ونضوج تبلورها، فقد أتاح ـ للمرة الأولى ـ المناخ المواتي للتشخيص الصحيح للأزمة، انعتاقا من ضلالات الرؤى الجزئية، وإدراكا لحقيقة أن الحرية والهوية والحداثة والعدالة والكرامة كلها سطور على لائحة “الثورة الشاملة”، التي نعرف أن كل ما سبق هو تمهيد لها، وأن “الماضي إن هو إلا مقدمة”.
ــــــــــــــــــــــــــ
From Liberty to Brest-Litovsk – BY: Ariadna Tyrkova-Williams (Mrs Harold Williams) – Macmillan and CO.,limited – London- 1919 – Chapter 1 “THE DOWNFALL OF THE OLD REGIME” – Page 4 “the mob in the labour district of the Vyborgsky was already looting the markets and parading the streets with shouts of “Bread!””.
وهو خطاب لا يختلف عن خطاب رئيس مصر الأسبق “أنور السادات” الذي سمى انتفاضة يناير 1977 الشعبية “انتفاضة الحرامية”. ولا عن خطاب خلفه “حسني مبارك” الذي اعتبر الثورة فوضى صائحا “أنا أو الفوضى”. إنه خطاب الطغاة والطغم العسكرية حيث كانت، وإن جاء على لسان “المعارضة” فلأنها “جزء من نظامهم”.
لا فرق هنا بين يمين ويسار، ولا تفاضل على أساس الوزن الجماهيري النسبي لهذه القوى، ببساطة لأنها ـ في سياقاتها وليس في أشخاصها ـ أجزاء من الدولة التي تحللت وجاءت الثورة لتكنسها [1].
[1] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات